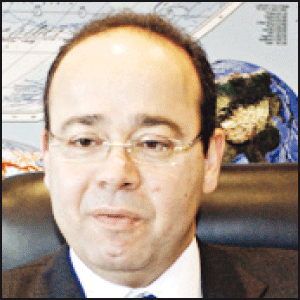
قد يبدو غريبا أن أتحدث عن التغيير ونحن مازلنا في أتون توابع الزلازل التي هزت استقرارنا بعنف حتى الآن. ولكني هنا أتحدث عن مفهوم التغيير الداعم للاستقرار، كل نظام ذكي في العالم يجدد نفسه بإحداث تغيير يضمن به استمرار سريان قوى الدفع والتحفيز للنظام والمجتمع. هذا يحدث حتى لو كان عمر النظام قصيرا أو حتى لو كان حديث العهد بإدارة العمل السياسي.
بعد قليل يكتشف النظام، أي نظام، مكامن الخلل في إدارته للشؤون الخاصة بالمجتمع، والفارق هنا بين نظام وآخر هو مدى شجاعته في إدراك الخطأ والمسارعة إلى تغييره. أذكر ما حكاه لي توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، عن تجربته في العامين الأولين، وكيف وجد نفسه وحكومته وبلده يتجهون إلى كارثة بسبب حداثة عهده وقتها هو وزملائه الوزراء في مسألة إدارة شؤون بلد كبير كالمملكة المتحدة، وهنا أدرك، كما قال لي، أهمية أن يتوقف ليعيد تنظيم البيت من الداخل، وأتي بمن يعرف في هذا الأمر والمتخصصين فيه لإعادة هيكلة ماكينة حكم البلاد التي يقودها. وبعد دراسة «علمية» على يد «علماء ومتخصصين» في الإدارة استطاع أن يمتلك تلك الماكينة التي جعلت من فترة حكمه واحدة من علامات التاريخ البريطاني الحديث، هذا بغض النظر عن أى تقييمات سياسية له ولحكمه.. ولكني أتحدث عن الإدارة.
إحدى القوى الكامنة في المجتمع البشرى هي قوي التغيير، وأظنها مثلها مثل قوى الطبيعة التي ظل الإنسان يهابها ويخافها، حتى تمكن من التعامل معها والسيطرة عليها نسبيا. دعونا نتخيل الإنسان الأول، الذي أظنه كان يفزع كلما تسببت العواصف في إحداث حريق، هو عبارة عن نيران لم يتمكن الإنسان الأول من إشعالها، وظلت قوة خفية وغير مسيطر عليها، حتى تمكن من التحكم في إشعال النار، وبذلك تخلص من خوفه منها واستطاع الاستفادة بها، وهكذا بقية القوى الأخرى التي يظل الإنسان متخوفا منها حتى يتمكن من السيطرة عليها أو توظيفها وفقا لاحتياجاته، ولو لم يتمكن من ذلك فإنه لا يملك إلا أن ينسحق أمامها أو يتجنبها. هكذا ظل الحال مع قوة الرياح والمياه والعواصف، وأظنه يصلح للتطبيق على قوة التغيير.
هذه المخاوف يمكن أن تنطبق على التعامل مع تلك القوة القديمة المتجددة، وهي الرغبة في التغيير، أو قوة التغيير، وهي تعيش الآن إحدى أعتى صورها وأفضل تجلياتها، ومثلها مثل القوى الأخرى التي ذكرت لها بعض الأمثلة، فقوة التغيير هي قوة قابلة للتوظيف الإيجابى، أو للانسحاق أمامها، المعيار هنا أو العنصر الحاسم هو: هل نقود نحن التغيير أم نقف متسمرين أمامه فلا نجد مستقبلا لنا إلا بانسحاقنا وفقا لقوانينه أو لقوانين من يحركه؟!
أظن أن المَخرَج الوحيد لأنظمتنا ولنا في هذه المرحلة أن نقود نحن عجلة التغيير بأيدينا، تلك العجلة التي بدأت في الدوران ولم يعد بإمكان شخص ما أو نظام ما القدرة على إيقافها أو دفعها إلى الوراء. قد يتمكن من وضع بعض العصى أثناء دوران هذه العجلة، ولكنه أبدا لن يتمكن من إيقافها، حتى لو نجح جزئيا في تعطيلها.
المطلوب في هذه المرحلة التجاوب مع قوة التغيير التى أصبحت المطلب الأول الآن بين الشعوب، هذا التجاوب يمكن أن يصب في صالح هذه الشعوب إذا ما حدث ذلك الاكتشاف المشترك بين الشعوب وحكامها لتلك النغمة المفتقدة بينهما. اكتشاف الأنظمة لغة حوار صحيحة مع شعوبها وقدرة هذه الأنظمة على تلبية رغبات تلك الشعوب في الحياة وفقا لمعايير تشعر هذه الشعوب بأنها تستحقها هو الأسلوب القادر على استعادة هذه الأنظمة لشعوبها ومكانتها بينها، وإذا ما عجزت تلك الأنظمة عن القيام بتلك المهمة، فإن ذلك لن يكون سوى دلالة على انتهاء صلاحية ذلك النظام. ولكى يتمكن النظام من التغلب على تلك الأزمة فلا سبيل أمامه إلا دفع قوى التغيير الحقيقية داخله لتتبوأ قيادة عجلة التغيير، وعلى الأنظمة في هذه اللحظة التخلص من كل من يحاول أن يضع عصا في عجلة التغيير المتحركة، أو من يحاول دفع عجلة التغيير من الخلف، مستعينا بقوى من خارج هذا المجتمع لتوجيه عجلة التغيير لتصب في إطار مصالح خاصة لفئة أو طائفة أو قوة خارجية، ولا يبقى لقيادة عجلة التغيير إلا أولئك المنتمون بحق لهذا المجتمع، والمؤمنون بأهمية هذا التغيير وتطويعه ليتحول إلى قوة مضافة وليس قوة هادمة.


















